|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 77639
|
|
الإنتساب : Mar 2013
|
|
المشاركات : 741
|
|
بمعدل : 0.18 يوميا
|
|
|
|
|
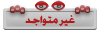

|
كاتب الموضوع :
alyatem
المنتدى :
المنتدى الفقهي
 بتاريخ : 08-04-2013 الساعة : 10:13 PM
بتاريخ : 08-04-2013 الساعة : 10:13 PM
البعد الأخلاقي في شخصية العلامة الفضلي
السيد حسن النمر **
 10 / 2 / 2007م -
تمهيد:
1- التقدير البالغ للقائمين على هذا التكريم الذي هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتسجيل حضور لمجتمعنا من خلال تكريم رموزه، خصوصاً مع اجتماع عوامل الإهمال والتهميش على تغييبه، من خلال رموزه.
2- لا تتسع أوراق قليلة للقيام بواجب الحديث عن شخصية بقامة العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي، ولا تسعف الفترة الزمنية التي خوطب بها مسطِّر هذه الأوراق، حيث لم تتجاوز أياماً معدوداتٍ.
3- تفرض الحقوق الكثيرة للعلامة المكرَّم، علينا عموماً وعلى راقم السطور خاصةً، المشاركةُ والقيامُ بما أمكن؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور.
4- ما سأذكره من شواهد هي معايشات شخصية، استقيتها على مدى أربعة عشر عاماً من التردد على سماحته في منـزله، ومشاركته في عدة نشاطات ثقافية وفكرية جمعتني وإياه، واختلافي الدائم والدائب على منـزله في مجلسه العام أو في لقاءات خاصة تشرفت بها لديه.
5- ما سأسجله، في هذه الوريقات، ليس بحثاً علمياًًّّ عن الأخلاق من وجهة نظر العلامة المكرَّم، وإنما هو انطباعات شخصية لما عايشته مباشرةً، بما وُفقت له من الاحتكاك المباشر بسماحته، سفراً[1] وحضراً، خلال أربعة عشر عاماً، أو قرأته من سيرة سماحته. دون أن أدعي الاستقصاء والاستيفاء، لأن في ذلك تقصيراً في حق الشيخ الفضلي، وقصوراً من مدعيه. وأرجو أن لا أكون أحد هذين، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[2] ، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.
المحطة الأولى: قَدَر الهجرة
قدر للعلامة الفضلي أن يألف الهجرة، فقد هاجر من «جنوب العراق»، حيث ولد في العام 1354 هـ، إلى «النجف الأشرف» حيث درس ودرّس حوزوياًّ، وتلقى أثناء ذلك دراساته العليا في الماجستير ببغداد، ثم هاجر ثانيةً إلى «مصر» طالباً للدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه، وأثناء ذلك هاجر إلى «جدة» أستاذاً أكاديمياًّ. حتى انتهى به المطاف بعد ملاحقات أمنية بعثية إلى الهجرة إلى حيث موطن آبائه وأجداده، حيث ألقى رحله أولاً في «سيهات» ومن بعدها أقام في الخبر لمدة سنة واحدة، ثم استقر أخيراً في «الدمام».
وقد حظي مجتمعنا بهجرة العلامة الفضلي إليه في العام 1409هـ، بعد سنين قضاها في مدينة جدة اشتغل فيها بالتدريس الجامعي في جامعة الملك عبد العزيز. وقد استقبلت جموع المؤمنين على اختلاف شرائحهم هجرته بالفرح والترحاب الحار لسببين اثنين:
• أولهما: ما تناهى إلى أسماعهم من مقام علمي شامخ لسماحته، شهد به أقرانه ومعاصروه. وما نُقل إليهم من كفاءات عدة تجمعت في شخصية لم تجتمع في أحد من أهل العلم في المنطقة من حيث الشمولية والجامعية، فقد كان الأول الذي جمع عنوانين لم يجتمعا في من سبقه من علماء الدين، وهما:
1 - أنه العالم الحوزوي المجتهد، الذي يذعن الجميع بأنه بلغ مرتبةً عالية في الدراسات الحوزوية، حتى أصبح من المبرَّزين من أساتذة حوزة النجف الأشرف بكل ما لها من الثقل العلمي المعروف.
2 - أنه الأستاذ الجامعي، الذي طاف بين أروقة جامعات مشهود لها بالإنتاج الغزير في تخريج الطلاب والأساتذة الأكفاء.
• ثانيهما: استشعار المجتمع، ونخبه خاصة، بالحاجة الماسّة إلى شخصية في مستوى العلامة الفضلي لإحداث نقلة نوعية في النشاط الديني الذي لم يعد قادراً، بصورته المعتادة، على تلبية احتياجاته الملحة، في زمن متسارع الخطى في حراكه وحراك ما حوله.
ولم تَخِب، بحمد الله، ظنون أوساطنا الاجتماعية، فما أن حط سماحة العلامة الفضلي رحله في أوساطه، وأخذ في ممارسة ما أمله المؤمنون منه، حتى نشطت محافل المؤمنين بالعديد من وجوه النشاط العلمي،لم تألفها سابقاً، فحدث ما يمكن أن نسميه بالنهضة الثقافية، تركت بصماتها على مختلف مناحي النشاط الديني، ولا تزال آثارها بيّنةً مشهودةً.
ولأني لست بصدد رصد تلكم النهضة الثقافية فلن أخوض في تفاصيلها، لأنها ليست موضوع هذه الأوراق، وآمل أن يقوم بذلك من يملك القدرة على التعريف بالمشهد الثقافي في مجتمعنا بعد قدوم سماحة العلامة الفضلي ومقارنته بالمشهد الثقافي قبل ذلك، مع الإشارة إلى الإسهام المباشر وغير المباشر لسماحته فيه.
وقد أحسن أبناء مجتمعنا استقبال العلامة الفضلي لما سمعوه، فلما أن عايشوه عن قرب وجدوا فيه بغيتهم من زاوية قد تكون مختلفة عما توقعوه، فلم يتصدَّ حفظه الله للعمل الديني في أوساطهم بالطريقة المتعارفة، فقد وجدوه مختلفاً في شكل تصديه حتى على مستوى اللباس، حيث لم يلبس العمامة التي اعتاد علماؤنا لبسها، ولم يعتمد الرداء «العباءة» التي اعتادوا لبسها، كما أنه لم يؤم الجماعة، وإلى ذلك لم يتصد إلى الوكالة الشرعية لمراجع التقليد الكبار، وقد كانت في متناوله، حيث كان واحداً من أبرز تلامذتهم ومورد اعتمادهم...
بل اعتمد نهجاً مختلفاً في التصدي للعمل الديني، بأن عكف على تغطية الجوانب المهملة، فكان دأبُهُ وديدنُهُ تحفيزَ الوسط الاجتماعي على تغيير الأنماط السائدة من الاهتمامات التي لم يعد من الصواب والحكمة الانكباب والاقتصار عليها شكلاً ومضموناً. فأخذ بالحض والحث على مبادرات في هذا الاتجاه، فصار العديد من المثقفين بصدد كتابة البحوث وعرضها على سماحته بغية طباعتها، فكان يقتطع من شيئاً من وقته الثمين لقراءتها وتسجيل الملاحظات التصويبية والتقويمية بنفسه، فلا يكاد أحد يقدم له مخطوطاً إلا ويشفعه بعد أيام قصيرة بدفتر أو أوراق من الملاحظات والتصويبات تؤكد أنه قرأه من الألف إلى الياء. دون أن يعني ذلك أن في هذا المخطوط شيئاً ذا قيمة تستدعي أن يتفرغ مثل سماحته لقراءته بهذه العناية والاهتمام به إلى درجة القيام بمهمة «مصحح»، لولا أنه «حفظه الله» أخذ على نفسه مهمة وجد أنها مقدسة عنوانها «النهوض الثقافي»، الذي يلازمه عادةً تواضع المستوى في البدايات.
وقد كان ذلك درساً لكل من التقى بسماحته في فن التواضع وتغليب المصلحة العامة وقداسة الهدف والغاية.
المحطة الثانية: صدمة الوعي العام
كانت أوساطنا الاجتماعية على صلة بنمط معين من علماء الدين يُقدس فيهم شخوصهم في جوانب ثلاثة:
• أولاً: المستوى العلمي بما حازه هذا العالم أو ذاك من علم بالدين ومعارفه مما تعارف في الأوساط الحوزوية دراسته وتدريسه.
• ثانياً: المستوى السلوكي والعملي، بما يتحلى به العالم أو طالب العلم من تُقى وورعٍ، يؤهله للقيام بما يتطلب ذلك من إمامة جماعة ونحوها.
• ثالثاً: على المستوى الذاتي والاجتماعي، بما يتحلى به عالم الدين وطالب العلم من زهد يبعده عن التهمة بالتهالك على الدنيا، ومزاحمة الغير.
ويتفاوت العلماء وطلبة العلم في التحلي بها.
غير أن لعلامتنا الفضلي سماتٍ أخرى، فهو إلى جانب تفوقه على المستوى العلمي حتى عُدَّ في الرعيل الأول من علماء مجتمعنا، فهو الفقيه المجاز بالاجتهاد، وهو الأستاذ الجامعي المربي للمئات من الجامعيين، والمشرف على العشرات من الأطروحات الجامعية، وهو، إلى ذلك، المثقف الموسوعي الذي يجد طلاب العلم والباحثون بغيتهم المنشودة لديه. وإلى جانب تحلِّيه بتقى وورعٍ مشهودين، وإلى جانب زهده الذي دفع به إلى الانقطاع إلى العلمِ والعملِ بعيداً عن الأضواء والإعلام وزخارف الشهرة الدنيوية.
إلى جانب ذلك، كله امتاز «حفظه الله» بمثابرة في العطاء، فهو لا يكلُّ ولا يَمَلُّ من الكتابة والمحاضرة وتقديم الكتب وتحقيقها[3] ، وحثّ المؤهلين للتصدي لذلك. وهذا ما لم يعتد عليه مجتمعنا، لعوامل ذاتية حيناً، وخارجية فرضت نفسها عليه حيناً آخر.
كما أنه «حفظ الله» امتاز بتجديد في عطائه، فقد فاجأ مجتمعَنا بنوع جديد من اهتمام عالم الدين، فلم يتصدَّ لما اعتاد الناس من عالم الدين التصدي له، كما ألمحنا إليه، وإنما أولى جل عنايته لما كان مهمَلاً من النشاط وترك إهماله آثاراً سلبيةً على النهوض الاجتماعي إلى حدّ التبلد والخمول.
فقد دعا إلى مسابقة بحثية في الأحساء، مُنعت لاحقاً، شارك فيها العديد من المهتمين.
كما أنه رعى مسابقة بحثية في القطيف، لم تستمر لدواعٍ أجهلها فعلاً، فاز فيها باحثون أصبح بعضهم من الكتاب المتمرسين فعلاً.
ورعى وشارك بهمةٍ ونشاطٍ، في بعض المهرجانات الثقافية التي تقام في شهر رمضان، ولا يزال بعضها مستمراً كمهرجان حسينية الناصر بسيهات، وهو أول تلك المهرجانات، لم يقطعه عن المشاركة فيه سوى ما ألم به من إرهاق وتعب ألقى بكلكله على جسده في السنتين الأخيرتين.
المحطة الثالثة: الطريق إلى المعالي
من سمات العلامة الفضلي الأخلاقية نـزوعه إلى الرقي والنهوض، على مستوى ذاته وعلى مستوى أمته. الأمر الذي انعكس على طبيعة اهتماماته في بناء نفسه وتخيُّر نشاطاته. فاتسعت اهتماماته بسعة الإسلام بين المسلمين. وازداد طموحه فبلغ من الكمال منـزلة جذبت إليه عشاق النهوض والرفعة.
فما أن تجلس في مجلسه حتى يتناهى إلى سمعك نمط جديد من الأسئلة والأجوبة والحوارات بين الشيخ وزواره، يختلف عما ألفه المؤمنون في أوساطنا الاجتماعية، من اهتمامات العلماء[4] . ليتكشف لك في شخصية العلامة الفضلي، أمران:
الأول: شمولية الهم
فلم يكن همه يقف عند وسطه الذي يعيش فيه، بل إنه يعيش همّ الأمة كلها في المشرق والمغرب، لذلك نجده متابعاً جيداً للصحف والمجلات، التي ينتقي منها ما وجد بالمتابعة دقة معلوماتها، دون أن يركن إلى ما ينقل، بل يعمد دائماً إلى التحليل والغربلة لتلك المعلومات، مستفيداً من:
أ - خبرته الواسعة في المجال العلمي بما يحمله من عمق معرفي في مختلف حقول المعرفة.
ب - خبرته في العمل العام الذي تصدى له في مختلف مراحل حياته، والتي مكنته من نفاذ في البصيرة وعمق في الرؤية.
لذلك فقد يتبنى موقفاً يفاجئك للوهلة الأولى، لتكتشف لاحقاً أن سماحته قرأ السطور وما وراءها، «وهو في هذا المجال صاحب تحليل دقيق وعميق، تشعر أنه يبالغ أحياناً، لتفاجئك تطورات الواقع أن له نظرة جد عميقة»[5] .
وكشاهد على ذلك: زرنا أحد الفضلاء في العام 1985 م في قم المقدسة، بعد رحلة الحج، وكان قد التقى بسماحة الشيخ الفضلي في «جدة». فسألناه عن أخباره، وموقفه من مسألة معينة. فأجاب: إن الشيخ متشائم وسوداوي النظرة. وكان هذا الفاضل من المتعجلين في اختياراته، كما تكشف لنا بعدُ. فإذا بالأيام تؤكد لنا أن نظر العلامة الفضلي كان ثاقباً وصائباً، بينما غيّر صاحبنا من قناعاته إلى حد الانقلاب على ما كان يبشر به آنذاك كما لو كان وحياً منـزلاً!!
وهو «حفظه الله» لا يرى انفكاكاً في الأزمات بين مجتمع إسلامي وآخر بسبب رقعة جغرافية، لذلك نجده يلاحق أخبار الأمة من هنا وهناك، ليتحسس آلاماً هنا، ويزهو بآمال هناك، يخفيها تارة ويبديها تارةً أخرى، تندُّ منه الآهةُ للألم مهما صغر، وتعلوه البهجة للأمل مهما تضاءل، لإدراكه أن العدو المتربص بالأمة يصل ليله بنهاره مقوِّضاً بنيانَ الأمة بشكل أو بآخر. ولعل ما يحصل في العراق خير شاهد على ذلك، فقد أقض احتلاله مضجع العلامة الفضلي، وقد سمعت منه مراراً وتكراراً، أثناء زياراتي المتكررة له، التحذير تلو التحذير من مخاطر ما يراد للأمة من مخطط إجرامي. وقد آلمه بما لا يقل عن ذلك بعض المظاهر الاجتماعية التي تكشف عن مدى الخلل الذي لحق بالشعب العراقي بسبب الإجرام الصدامي، الذي سعى إلى حرمان الأمة من تشييد نهضتها على أساس العلم والمعرفة، قبل أي شيء آخر، باعتباره منتجاً للإيمان الرشيد.
الثاني: بُعد الهمة
أعتقد أنه «حفظه الله» يتسم بهمة عالية دفعت به إلى الإقدام على ما يعجز عنه كثيرون، وإلى التخطيط الدقيق للعديد من الخطوات والعمل على تنفيذها، وأذكر على ذلك هذا الشاهد:
ألح على سماحته هاجس التجديد في المناهج الدراسية الحوزوية، لأسباب عدة ليس هذا محل ذكرها، فأخذ في تنفيذ ذلك على مدى سنوات امتدت لأربعة وأربعين عاماً بدءً بالعام 1383 هـ، هو سنة تأليفه لكتاب «خلاصة علم المنطق»، وانتهاءً إلى العام 1427 هـ حيث لا يزال مشغولاً بكتابة موسوعته مبادئ علم الفقه. غطى فيها مساحة شملت أغلب العلوم المتداولة في الوسط الحوزوي. وهي فترة، لا يعمل فيها إلا ذوو الهمة العالية، وهي السمة التي أشاد بها فيه شيخه المجيز له بالرواية الشيخ بزرك الطهراني «رحمه الله»، حيث قال في إجازته له ولما يتجاوز العشرين سنة من العمر: الشيخ الفاضل البارع، الشاب المقبل، الواصل في حداثة سنه إلى أعلى مراقي الكمال، والبالغ من الفضائل مبلغاً لا يُنال إلا بالكدّ الأكيد من كبار الرجال»[6] .
المحطة الرابعة: نبل الذات
لم يحظَ العلامة الفضلي بما حظي به من قبول واسع واحترام كبير في الوسط الاجتماعي، بسبب علمه فحسب، فالعلماء كثر، ولا بسبب تقواه وزهده فقط، فهؤلاء أيضاً ليسوا قلة، وإنما حظي بذلك بسبب علمه وتقواه وزهده، مضافاً إليه عددٌ من السِّمات التي جعلت منه مشروع «الأمل» المفقود، لمجتمع عملت أسباب الحرمان على تهميشه وتغييبه مع كل ما يملكه منذ صدر الإسلام على مقومات النهضة الشاملة، مادياًّ ومعنوياًّ.
ولعل تلك السمات تنبع من «نبل الذات» الذي تميز به علامتنا الفضلي «حفظه الله» بشكل بارز، ومنها:
السمة الأولى: صدق الانتماء للدين والمجتمع
يسوغ لي أن أقول إن الانتماء يأخذ شكلين اثنين:
الأول: الانتماء الفكري
وهو مجموعة القناعات التي يؤمن بها «المنتمي» وتكون محركاً له للإقدام والإحجام، ويصنف المنتمون، لأي فكر، إلى صنفين:
1 - منتمين على بصيرة.
2 - منتمين على غير بصيرة.
وبعيداً عن الخوض في التفاصيل، فقد لمست في العلامة الفضلي: انتماءً صادقاً للدين يتجاوز الادعاء، لقناعته الراسخة أن خلاصه الشخصي وخلاص أمته في علو الدين وتغلغل تعاليمه في نفوس الناس وهيمنته على جوانب حياتهم الفردية والاجتماعية... ومن ثم فإن ما يشغل مجلسه من أحاديث لا يتجاوز همّ الدين وأهله»[7] .
الثاني: الانتماء الاجتماعي
يتفاوت العلماء، وهم القادة الاجتماعيون، في إحداث التغيير الاجتماعي، بحسب ما يملك هذا أو ذاك من وسائل التأثير. ومن أهم تلك الوسائل شعور الأمة/ المجتمع بأن ما يقوله العالم ويطلبه القائد يعود إلى المجتمع نفسه بالنفع، لأن التغيير أمر ينبع من تبدل القناعات الداخلية لدى الفرد والمجتمع تدفع به إلى تغيير سلوك أو تطوير إرادة...
وقد يكون لدى العالم صدق في الانتماء للمجتمع لكنه لا يحسن التعبير عنه، لذلك فالمطلوب أمران:
الأول: صدق الانتماء.
وهذا إنما يحصل بالتقوى أولاً، وبحب الناس ثانياً. فمن لا تقوى لديه لن يكون صادقاً في انتمائه لمجتمعه لأن أنانيته ستشكل حجاباً غليظاً بينه وبين رغبات الآخرين «المجتمع»، كما أن من لا يحب الناسَ لن يتحلى بالانتماء، وبالتالي لن يُطالب بالصدق فيه.
الثاني: حسن التعبير عن الصدق.
فقد يكون بعض الناس منتمياً لمجتمعه، وهو صادق في ذلك، لكنه يقع في بعض ما يكون سبباً لهز ثقة المجتمع فيه. ومن ثم فإن المطلوب هو التحلي بأعلى درجة من المناقبية والنـزاهة، لئلا تُترك ثغرةٌ تكون سبباً لإحداث اهتزاز في الثقة.
ولعل العلامة الفضلي توفر على هذين الأمرين بشكل كبير، لعوامل ذاتية وموضوعية لا أستطيع تفصيلها الآن، جعلت من الوسط الاجتماعي، على اختلاف مشاربه وانتماءاته، يرى في سماحته «المنتمي» له، مما هيأ له تبوأ مرتبة عالية من المقبولية تجعله في مصافِّ «القادة».
فلم يقع سماحته في خصومة ولا نـزاع مع أحد ولا جهة، كما لم يقع في ممارسة تجعل بينه وبين طيف من أطياف هذا المجتمع حاجزاً عن إمكانية التأثير فيه، بل بقي على مسافة واحدة من الجميع، دون أن يتخلى عن قناعاته التي قد يختلف وآخرين حولها.
السمة الثانية: الشجاعة
تحلى سماحة العلامة الفضلي بشجاعة نادرة، لم يتوفر عليه كثيرون. وقد أخذت شجاعته أشكالاً، أشير إلى بعضها ضمن الشواهد التالية:
الشاهد الأول: انتسابه لكلية الفقه
ولعلك تُفاجأ، أخي القارئ بذكر انتسابه لكلية علمية في وسط علمي، وأبادر إلى تبديد وهمك لأشير إلى أن للأوساط العريقة، في أي مجال، تقاليد وأعرافاً ليس من السهل تغييرها واستبدالها، خصوصاً إذا كانت جذرية.
ولم تكن النجف ذات التاريخ الممتد لأزيد من الألف عام استثناءً، فلها بدورها تقاليدها المدرسية والسلوكية العريقة، فليس مسموحاً، آنذاك، لطالب العلم أن يدرس أي علم، ولا أن يتصرف كما شاء، ولا أن يقوم بما يحلو له... لأن عليه أن يلتزم ما درج عليه العلماء في تلك الأوساط ليشهدوا له بدورهم، أنهم تولوا تربيته على ما ينبغي أن يكون عليه، وتتقبله الأمة بتلكم التزكية.
وبطبيعة الحال، فإن تلكم التقاليد لم تكن بأجمعها صائبة، كما أن بعضها الآخر الذي يمكن أن يكون صائباً في جوهره، ليس هو كذلك بالضرورة في شكله، لأن للتغيرات الاجتماعية متطلباتها التي لابد من الاستجابة لها، في حدود ما لا يتنافى والثوابت، ويصطدم بالخطوط الحمر.
في هذا الجو المتشدد والمتصلِّب نشأ الشيخ الفضلي، حيث الصراع المحموم بين القديم والجديد، فاختار بكل شجاعة أن ينحاز للجديد، بعد أن وجد فيه ضالته المنشودة من الموائمة بين ثوابت الإسلام وأحكامه من جهة، ومتطلبات العصر من جهة ثانية. فترجم ذلك بالانتساب إلى كلية الفقه أولاً، مواصلاً مسيرته الأكاديمية في جامعة بغداد، انتهاءً بجامعة الأزهر بمصر.
وهذه المسيرة كانت مرّة وقاسية على مثل الشيخ الفضلي آنذاك لأن الوضع لم يكن يتقبل ذاك بسلاسة. وما أصعب أن تخالف ما هو سائد، وما أحوجك إلى أن تكون شجاعاً لتقوم به.
الشاهد الثاني: انتماؤه للعمل الإسلامي المنظم
في هذا الجو نفسه استشعر علامتنا الفضلي، وثلةٌ من أهل العلم والغيرة آنذاك، الحاجةَ الماسّةَ إلى تنظيم يقوم على أساس تأمين الحاجة الاجتماعية للتربية الدينية وجني ثمارها، فلم يجد حرجاً في الانتماء، مع ما لفّ ذلك من مخاطر أمنية، حيث المنع الرسمي من قبل الدولة، ومخاطر اجتماعية، حيث الرفض الاجتماعي المطلق في الوسط الحوزوي لدى علماء الدين وطلبة العلم لذلك. ومع هذا وذاك اختار العلامة المكرّم ما وجد أنه صواباً وضرورةً، ولمس الشجاعة في نفسه لاختياره ذاك.
وقد عُرِفت حوزة النجف الأشرف بالصرامة والتقليدية، حرصاً من رموزها وطلابها، على المحافظة على ما يطمئن إلى سلامته وصوابيته لقيام الدليل عليه. الأمر الذي انعكس سلباً على وتيرة التفاعل بين الحوزة العلمية ومستجدات الأحداث. وقد عاصر سماحة علامتنا المكرّم حقبة التمدد الشيوعي والتمرد على التعاليم والمعارف الدينية في العراق إبان حكم عبد الكريم قاسم «1958 - 1963 م». فنشأت فكرة التنظيم الإسلامي، فكان لسماحته شرف الريادة في الانخراط فيه فكان من قياداته ذوي التأثير.
وكان شجاعاً وتقدمياًّ جداًّ في انتسابه وعمله ذاك، بعد أن آمن بصواب الفكرة مع شدة رفضها من قبل قطاعات واسعة في الوسط الحوزوي[8] .
الشاهد الثالث: ممارسة الكتابة والتأليف
لم يكن من المعتاد لدى الأوساط الحوزوية العامة في النجف الأشرف، آنئذٍ، الكتابةُ والتأليفُ في غير العلوم الحوزوية المتعارفة، لذلك فإن من كتب، حينها، وألّف في غير ما تعارف التأليف فيه، عانوا أشد المعاناة، من الاتهام بالفشل الحوزوي، مروراً بأنهم صحفيون، انتهاءً بالتمرد على تقاليد الحوزة. ولهذه التهم وأمثالها قدرة تدميرية هائلة، يستجيب كثير من طلبة العلم لضغطها، تحول بينهم وبين تفجير طاقاتهم الهائلة في التأليف والكتابة.
الشاهد الرابع: احترام حق الغير في الاختيار
قد يحكم الركود الفكري وسطاً من الأوساط العلمية، فما أن يتبنى أحدٌ رأياً «آخر» غير ما هو مألوف، حتى تثار العواصف في وجهه. ولم يكن سماحته ممن يتبنى وجهة النظر هذه، فهو يرى أن من حق صاحب الرأي أن يقول رأيه في حدود الاجتهاد الفكري بعد اكتمال مقدماته وقواعده. وليس لأحد ممارسة الوصاية عليه. وللآخرين الحق أن يُبدوا آراءهم المخالفة، لكن في حدود الاختلاف العلمي دون تجريح شخصي.
وكان يمارس ذلك عملياًّ فبينما نجد بعض أهل العلم يتكتم على «الرأي الآخر»، وقد يضيف إلى ذلك التنكر له ولعلمه، لدواعٍ علمية تارةً، وغير علمية تارةً أخرى. أما الشيخ فلم يكن، فيما عهدته منه، ينطلق من هذا المنطلق، بل كان موضوعياًّ في منتهى الموضوعية، فإذا كان بصدد بحثٍ علميٍّ فإنه يجنبه تماماً من ميوله واختياراته، ليتولى عرض الرأي الآخر بكل ما تتطلبه الموضوعية من الإنصاف. فإذا تطلب المقام المناقشة فإنه يدخل فيها بما ينبغي للعالم أن يراعيه من أصول البحث العلمي.
وسأكتفي بإحالة القارئ الكريم إلى مجموع كتب الشيخ ومحاضراته التي تزخر بالشواهد، على ما قلناه من عرض الرأي والرأي الآخر دون تحيز لطرف دون طرف، ثم الوصول إلى مرحلة الاختيار حسب القواعد العلمية.
وأقتصر على ما نقله لي من أنه لما سافر إلى اليمن أخذ بالبحث عن كتب لعالم يمني، سمع أنه يرى التفرقة بين الفائدة البنكية المعروفة والربا المنصوص على حرمته بين الفقهاء، ليكتب عن رأيه بأدلته التي ساقها صاحب النظرية. وهو شاهد على نبل أخلاقي يفتقده كثيرون بذريعة أن المسألة واضحةٌ ومتفقٌ عليها! مع أن وضوح المسألة والاتفاق عليها، كما لا يخفى، ليسا مسوِّغاً كافياً للتعتيم والتجاهل.
10 / 2 / 2007م -
تمهيد:
1- التقدير البالغ للقائمين على هذا التكريم الذي هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتسجيل حضور لمجتمعنا من خلال تكريم رموزه، خصوصاً مع اجتماع عوامل الإهمال والتهميش على تغييبه، من خلال رموزه.
2- لا تتسع أوراق قليلة للقيام بواجب الحديث عن شخصية بقامة العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي، ولا تسعف الفترة الزمنية التي خوطب بها مسطِّر هذه الأوراق، حيث لم تتجاوز أياماً معدوداتٍ.
3- تفرض الحقوق الكثيرة للعلامة المكرَّم، علينا عموماً وعلى راقم السطور خاصةً، المشاركةُ والقيامُ بما أمكن؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور.
4- ما سأذكره من شواهد هي معايشات شخصية، استقيتها على مدى أربعة عشر عاماً من التردد على سماحته في منـزله، ومشاركته في عدة نشاطات ثقافية وفكرية جمعتني وإياه، واختلافي الدائم والدائب على منـزله في مجلسه العام أو في لقاءات خاصة تشرفت بها لديه.
5- ما سأسجله، في هذه الوريقات، ليس بحثاً علمياًًّّ عن الأخلاق من وجهة نظر العلامة المكرَّم، وإنما هو انطباعات شخصية لما عايشته مباشرةً، بما وُفقت له من الاحتكاك المباشر بسماحته، سفراً[1] وحضراً، خلال أربعة عشر عاماً، أو قرأته من سيرة سماحته. دون أن أدعي الاستقصاء والاستيفاء، لأن في ذلك تقصيراً في حق الشيخ الفضلي، وقصوراً من مدعيه. وأرجو أن لا أكون أحد هذين، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[2] ، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.
المحطة الأولى: قَدَر الهجرة
قدر للعلامة الفضلي أن يألف الهجرة، فقد هاجر من «جنوب العراق»، حيث ولد في العام 1354 هـ، إلى «النجف الأشرف» حيث درس ودرّس حوزوياًّ، وتلقى أثناء ذلك دراساته العليا في الماجستير ببغداد، ثم هاجر ثانيةً إلى «مصر» طالباً للدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه، وأثناء ذلك هاجر إلى «جدة» أستاذاً أكاديمياًّ. حتى انتهى به المطاف بعد ملاحقات أمنية بعثية إلى الهجرة إلى حيث موطن آبائه وأجداده، حيث ألقى رحله أولاً في «سيهات» ومن بعدها أقام في الخبر لمدة سنة واحدة، ثم استقر أخيراً في «الدمام».
وقد حظي مجتمعنا بهجرة العلامة الفضلي إليه في العام 1409هـ، بعد سنين قضاها في مدينة جدة اشتغل فيها بالتدريس الجامعي في جامعة الملك عبد العزيز. وقد استقبلت جموع المؤمنين على اختلاف شرائحهم هجرته بالفرح والترحاب الحار لسببين اثنين:
• أولهما: ما تناهى إلى أسماعهم من مقام علمي شامخ لسماحته، شهد به أقرانه ومعاصروه. وما نُقل إليهم من كفاءات عدة تجمعت في شخصية لم تجتمع في أحد من أهل العلم في المنطقة من حيث الشمولية والجامعية، فقد كان الأول الذي جمع عنوانين لم يجتمعا في من سبقه من علماء الدين، وهما:
1 - أنه العالم الحوزوي المجتهد، الذي يذعن الجميع بأنه بلغ مرتبةً عالية في الدراسات الحوزوية، حتى أصبح من المبرَّزين من أساتذة حوزة النجف الأشرف بكل ما لها من الثقل العلمي المعروف.
2 - أنه الأستاذ الجامعي، الذي طاف بين أروقة جامعات مشهود لها بالإنتاج الغزير في تخريج الطلاب والأساتذة الأكفاء.
• ثانيهما: استشعار المجتمع، ونخبه خاصة، بالحاجة الماسّة إلى شخصية في مستوى العلامة الفضلي لإحداث نقلة نوعية في النشاط الديني الذي لم يعد قادراً، بصورته المعتادة، على تلبية احتياجاته الملحة، في زمن متسارع الخطى في حراكه وحراك ما حوله.
ولم تَخِب، بحمد الله، ظنون أوساطنا الاجتماعية، فما أن حط سماحة العلامة الفضلي رحله في أوساطه، وأخذ في ممارسة ما أمله المؤمنون منه، حتى نشطت محافل المؤمنين بالعديد من وجوه النشاط العلمي،لم تألفها سابقاً، فحدث ما يمكن أن نسميه بالنهضة الثقافية، تركت بصماتها على مختلف مناحي النشاط الديني، ولا تزال آثارها بيّنةً مشهودةً.
ولأني لست بصدد رصد تلكم النهضة الثقافية فلن أخوض في تفاصيلها، لأنها ليست موضوع هذه الأوراق، وآمل أن يقوم بذلك من يملك القدرة على التعريف بالمشهد الثقافي في مجتمعنا بعد قدوم سماحة العلامة الفضلي ومقارنته بالمشهد الثقافي قبل ذلك، مع الإشارة إلى الإسهام المباشر وغير المباشر لسماحته فيه.
وقد أحسن أبناء مجتمعنا استقبال العلامة الفضلي لما سمعوه، فلما أن عايشوه عن قرب وجدوا فيه بغيتهم من زاوية قد تكون مختلفة عما توقعوه، فلم يتصدَّ حفظه الله للعمل الديني في أوساطهم بالطريقة المتعارفة، فقد وجدوه مختلفاً في شكل تصديه حتى على مستوى اللباس، حيث لم يلبس العمامة التي اعتاد علماؤنا لبسها، ولم يعتمد الرداء «العباءة» التي اعتادوا لبسها، كما أنه لم يؤم الجماعة، وإلى ذلك لم يتصد إلى الوكالة الشرعية لمراجع التقليد الكبار، وقد كانت في متناوله، حيث كان واحداً من أبرز تلامذتهم ومورد اعتمادهم...
بل اعتمد نهجاً مختلفاً في التصدي للعمل الديني، بأن عكف على تغطية الجوانب المهملة، فكان دأبُهُ وديدنُهُ تحفيزَ الوسط الاجتماعي على تغيير الأنماط السائدة من الاهتمامات التي لم يعد من الصواب والحكمة الانكباب والاقتصار عليها شكلاً ومضموناً. فأخذ بالحض والحث على مبادرات في هذا الاتجاه، فصار العديد من المثقفين بصدد كتابة البحوث وعرضها على سماحته بغية طباعتها، فكان يقتطع من شيئاً من وقته الثمين لقراءتها وتسجيل الملاحظات التصويبية والتقويمية بنفسه، فلا يكاد أحد يقدم له مخطوطاً إلا ويشفعه بعد أيام قصيرة بدفتر أو أوراق من الملاحظات والتصويبات تؤكد أنه قرأه من الألف إلى الياء. دون أن يعني ذلك أن في هذا المخطوط شيئاً ذا قيمة تستدعي أن يتفرغ مثل سماحته لقراءته بهذه العناية والاهتمام به إلى درجة القيام بمهمة «مصحح»، لولا أنه «حفظه الله» أخذ على نفسه مهمة وجد أنها مقدسة عنوانها «النهوض الثقافي»، الذي يلازمه عادةً تواضع المستوى في البدايات.
وقد كان ذلك درساً لكل من التقى بسماحته في فن التواضع وتغليب المصلحة العامة وقداسة الهدف والغاية.
المحطة الثانية: صدمة الوعي العام
كانت أوساطنا الاجتماعية على صلة بنمط معين من علماء الدين يُقدس فيهم شخوصهم في جوانب ثلاثة:
• أولاً: المستوى العلمي بما حازه هذا العالم أو ذاك من علم بالدين ومعارفه مما تعارف في الأوساط الحوزوية دراسته وتدريسه.
• ثانياً: المستوى السلوكي والعملي، بما يتحلى به العالم أو طالب العلم من تُقى وورعٍ، يؤهله للقيام بما يتطلب ذلك من إمامة جماعة ونحوها.
• ثالثاً: على المستوى الذاتي والاجتماعي، بما يتحلى به عالم الدين وطالب العلم من زهد يبعده عن التهمة بالتهالك على الدنيا، ومزاحمة الغير.
ويتفاوت العلماء وطلبة العلم في التحلي بها.
غير أن لعلامتنا الفضلي سماتٍ أخرى، فهو إلى جانب تفوقه على المستوى العلمي حتى عُدَّ في الرعيل الأول من علماء مجتمعنا، فهو الفقيه المجاز بالاجتهاد، وهو الأستاذ الجامعي المربي للمئات من الجامعيين، والمشرف على العشرات من الأطروحات الجامعية، وهو، إلى ذلك، المثقف الموسوعي الذي يجد طلاب العلم والباحثون بغيتهم المنشودة لديه. وإلى جانب تحلِّيه بتقى وورعٍ مشهودين، وإلى جانب زهده الذي دفع به إلى الانقطاع إلى العلمِ والعملِ بعيداً عن الأضواء والإعلام وزخارف الشهرة الدنيوية.
إلى جانب ذلك، كله امتاز «حفظه الله» بمثابرة في العطاء، فهو لا يكلُّ ولا يَمَلُّ من الكتابة والمحاضرة وتقديم الكتب وتحقيقها[3] ، وحثّ المؤهلين للتصدي لذلك. وهذا ما لم يعتد عليه مجتمعنا، لعوامل ذاتية حيناً، وخارجية فرضت نفسها عليه حيناً آخر.
كما أنه «حفظ الله» امتاز بتجديد في عطائه، فقد فاجأ مجتمعَنا بنوع جديد من اهتمام عالم الدين، فلم يتصدَّ لما اعتاد الناس من عالم الدين التصدي له، كما ألمحنا إليه، وإنما أولى جل عنايته لما كان مهمَلاً من النشاط وترك إهماله آثاراً سلبيةً على النهوض الاجتماعي إلى حدّ التبلد والخمول.
فقد دعا إلى مسابقة بحثية في الأحساء، مُنعت لاحقاً، شارك فيها العديد من المهتمين.
كما أنه رعى مسابقة بحثية في القطيف، لم تستمر لدواعٍ أجهلها فعلاً، فاز فيها باحثون أصبح بعضهم من الكتاب المتمرسين فعلاً.
ورعى وشارك بهمةٍ ونشاطٍ، في بعض المهرجانات الثقافية التي تقام في شهر رمضان، ولا يزال بعضها مستمراً كمهرجان حسينية الناصر بسيهات، وهو أول تلك المهرجانات، لم يقطعه عن المشاركة فيه سوى ما ألم به من إرهاق وتعب ألقى بكلكله على جسده في السنتين الأخيرتين.
المحطة الثالثة: الطريق إلى المعالي
من سمات العلامة الفضلي الأخلاقية نـزوعه إلى الرقي والنهوض، على مستوى ذاته وعلى مستوى أمته. الأمر الذي انعكس على طبيعة اهتماماته في بناء نفسه وتخيُّر نشاطاته. فاتسعت اهتماماته بسعة الإسلام بين المسلمين. وازداد طموحه فبلغ من الكمال منـزلة جذبت إليه عشاق النهوض والرفعة.
فما أن تجلس في مجلسه حتى يتناهى إلى سمعك نمط جديد من الأسئلة والأجوبة والحوارات بين الشيخ وزواره، يختلف عما ألفه المؤمنون في أوساطنا الاجتماعية، من اهتمامات العلماء[4] . ليتكشف لك في شخصية العلامة الفضلي، أمران:
الأول: شمولية الهم
فلم يكن همه يقف عند وسطه الذي يعيش فيه، بل إنه يعيش همّ الأمة كلها في المشرق والمغرب، لذلك نجده متابعاً جيداً للصحف والمجلات، التي ينتقي منها ما وجد بالمتابعة دقة معلوماتها، دون أن يركن إلى ما ينقل، بل يعمد دائماً إلى التحليل والغربلة لتلك المعلومات، مستفيداً من:
أ - خبرته الواسعة في المجال العلمي بما يحمله من عمق معرفي في مختلف حقول المعرفة.
ب - خبرته في العمل العام الذي تصدى له في مختلف مراحل حياته، والتي مكنته من نفاذ في البصيرة وعمق في الرؤية.
لذلك فقد يتبنى موقفاً يفاجئك للوهلة الأولى، لتكتشف لاحقاً أن سماحته قرأ السطور وما وراءها، «وهو في هذا المجال صاحب تحليل دقيق وعميق، تشعر أنه يبالغ أحياناً، لتفاجئك تطورات الواقع أن له نظرة جد عميقة»[5] .
وكشاهد على ذلك: زرنا أحد الفضلاء في العام 1985 م في قم المقدسة، بعد رحلة الحج، وكان قد التقى بسماحة الشيخ الفضلي في «جدة». فسألناه عن أخباره، وموقفه من مسألة معينة. فأجاب: إن الشيخ متشائم وسوداوي النظرة. وكان هذا الفاضل من المتعجلين في اختياراته، كما تكشف لنا بعدُ. فإذا بالأيام تؤكد لنا أن نظر العلامة الفضلي كان ثاقباً وصائباً، بينما غيّر صاحبنا من قناعاته إلى حد الانقلاب على ما كان يبشر به آنذاك كما لو كان وحياً منـزلاً!!
وهو «حفظه الله» لا يرى انفكاكاً في الأزمات بين مجتمع إسلامي وآخر بسبب رقعة جغرافية، لذلك نجده يلاحق أخبار الأمة من هنا وهناك، ليتحسس آلاماً هنا، ويزهو بآمال هناك، يخفيها تارة ويبديها تارةً أخرى، تندُّ منه الآهةُ للألم مهما صغر، وتعلوه البهجة للأمل مهما تضاءل، لإدراكه أن العدو المتربص بالأمة يصل ليله بنهاره مقوِّضاً بنيانَ الأمة بشكل أو بآخر. ولعل ما يحصل في العراق خير شاهد على ذلك، فقد أقض احتلاله مضجع العلامة الفضلي، وقد سمعت منه مراراً وتكراراً، أثناء زياراتي المتكررة له، التحذير تلو التحذير من مخاطر ما يراد للأمة من مخطط إجرامي. وقد آلمه بما لا يقل عن ذلك بعض المظاهر الاجتماعية التي تكشف عن مدى الخلل الذي لحق بالشعب العراقي بسبب الإجرام الصدامي، الذي سعى إلى حرمان الأمة من تشييد نهضتها على أساس العلم والمعرفة، قبل أي شيء آخر، باعتباره منتجاً للإيمان الرشيد.
الثاني: بُعد الهمة
أعتقد أنه «حفظه الله» يتسم بهمة عالية دفعت به إلى الإقدام على ما يعجز عنه كثيرون، وإلى التخطيط الدقيق للعديد من الخطوات والعمل على تنفيذها، وأذكر على ذلك هذا الشاهد:
ألح على سماحته هاجس التجديد في المناهج الدراسية الحوزوية، لأسباب عدة ليس هذا محل ذكرها، فأخذ في تنفيذ ذلك على مدى سنوات امتدت لأربعة وأربعين عاماً بدءً بالعام 1383 هـ، هو سنة تأليفه لكتاب «خلاصة علم المنطق»، وانتهاءً إلى العام 1427 هـ حيث لا يزال مشغولاً بكتابة موسوعته مبادئ علم الفقه. غطى فيها مساحة شملت أغلب العلوم المتداولة في الوسط الحوزوي. وهي فترة، لا يعمل فيها إلا ذوو الهمة العالية، وهي السمة التي أشاد بها فيه شيخه المجيز له بالرواية الشيخ بزرك الطهراني «رحمه الله»، حيث قال في إجازته له ولما يتجاوز العشرين سنة من العمر: الشيخ الفاضل البارع، الشاب المقبل، الواصل في حداثة سنه إلى أعلى مراقي الكمال، والبالغ من الفضائل مبلغاً لا يُنال إلا بالكدّ الأكيد من كبار الرجال»[6] .
المحطة الرابعة: نبل الذات
لم يحظَ العلامة الفضلي بما حظي به من قبول واسع واحترام كبير في الوسط الاجتماعي، بسبب علمه فحسب، فالعلماء كثر، ولا بسبب تقواه وزهده فقط، فهؤلاء أيضاً ليسوا قلة، وإنما حظي بذلك بسبب علمه وتقواه وزهده، مضافاً إليه عددٌ من السِّمات التي جعلت منه مشروع «الأمل» المفقود، لمجتمع عملت أسباب الحرمان على تهميشه وتغييبه مع كل ما يملكه منذ صدر الإسلام على مقومات النهضة الشاملة، مادياًّ ومعنوياًّ.
ولعل تلك السمات تنبع من «نبل الذات» الذي تميز به علامتنا الفضلي «حفظه الله» بشكل بارز، ومنها:
السمة الأولى: صدق الانتماء للدين والمجتمع
يسوغ لي أن أقول إن الانتماء يأخذ شكلين اثنين:
الأول: الانتماء الفكري
وهو مجموعة القناعات التي يؤمن بها «المنتمي» وتكون محركاً له للإقدام والإحجام، ويصنف المنتمون، لأي فكر، إلى صنفين:
1 - منتمين على بصيرة.
2 - منتمين على غير بصيرة.
وبعيداً عن الخوض في التفاصيل، فقد لمست في العلامة الفضلي: انتماءً صادقاً للدين يتجاوز الادعاء، لقناعته الراسخة أن خلاصه الشخصي وخلاص أمته في علو الدين وتغلغل تعاليمه في نفوس الناس وهيمنته على جوانب حياتهم الفردية والاجتماعية... ومن ثم فإن ما يشغل مجلسه من أحاديث لا يتجاوز همّ الدين وأهله»[7] .
الثاني: الانتماء الاجتماعي
يتفاوت العلماء، وهم القادة الاجتماعيون، في إحداث التغيير الاجتماعي، بحسب ما يملك هذا أو ذاك من وسائل التأثير. ومن أهم تلك الوسائل شعور الأمة/ المجتمع بأن ما يقوله العالم ويطلبه القائد يعود إلى المجتمع نفسه بالنفع، لأن التغيير أمر ينبع من تبدل القناعات الداخلية لدى الفرد والمجتمع تدفع به إلى تغيير سلوك أو تطوير إرادة...
وقد يكون لدى العالم صدق في الانتماء للمجتمع لكنه لا يحسن التعبير عنه، لذلك فالمطلوب أمران:
الأول: صدق الانتماء.
وهذا إنما يحصل بالتقوى أولاً، وبحب الناس ثانياً. فمن لا تقوى لديه لن يكون صادقاً في انتمائه لمجتمعه لأن أنانيته ستشكل حجاباً غليظاً بينه وبين رغبات الآخرين «المجتمع»، كما أن من لا يحب الناسَ لن يتحلى بالانتماء، وبالتالي لن يُطالب بالصدق فيه.
الثاني: حسن التعبير عن الصدق.
فقد يكون بعض الناس منتمياً لمجتمعه، وهو صادق في ذلك، لكنه يقع في بعض ما يكون سبباً لهز ثقة المجتمع فيه. ومن ثم فإن المطلوب هو التحلي بأعلى درجة من المناقبية والنـزاهة، لئلا تُترك ثغرةٌ تكون سبباً لإحداث اهتزاز في الثقة.
ولعل العلامة الفضلي توفر على هذين الأمرين بشكل كبير، لعوامل ذاتية وموضوعية لا أستطيع تفصيلها الآن، جعلت من الوسط الاجتماعي، على اختلاف مشاربه وانتماءاته، يرى في سماحته «المنتمي» له، مما هيأ له تبوأ مرتبة عالية من المقبولية تجعله في مصافِّ «القادة».
فلم يقع سماحته في خصومة ولا نـزاع مع أحد ولا جهة، كما لم يقع في ممارسة تجعل بينه وبين طيف من أطياف هذا المجتمع حاجزاً عن إمكانية التأثير فيه، بل بقي على مسافة واحدة من الجميع، دون أن يتخلى عن قناعاته التي قد يختلف وآخرين حولها.
السمة الثانية: الشجاعة
تحلى سماحة العلامة الفضلي بشجاعة نادرة، لم يتوفر عليه كثيرون. وقد أخذت شجاعته أشكالاً، أشير إلى بعضها ضمن الشواهد التالية:
الشاهد الأول: انتسابه لكلية الفقه
ولعلك تُفاجأ، أخي القارئ بذكر انتسابه لكلية علمية في وسط علمي، وأبادر إلى تبديد وهمك لأشير إلى أن للأوساط العريقة، في أي مجال، تقاليد وأعرافاً ليس من السهل تغييرها واستبدالها، خصوصاً إذا كانت جذرية.
ولم تكن النجف ذات التاريخ الممتد لأزيد من الألف عام استثناءً، فلها بدورها تقاليدها المدرسية والسلوكية العريقة، فليس مسموحاً، آنذاك، لطالب العلم أن يدرس أي علم، ولا أن يتصرف كما شاء، ولا أن يقوم بما يحلو له... لأن عليه أن يلتزم ما درج عليه العلماء في تلك الأوساط ليشهدوا له بدورهم، أنهم تولوا تربيته على ما ينبغي أن يكون عليه، وتتقبله الأمة بتلكم التزكية.
وبطبيعة الحال، فإن تلكم التقاليد لم تكن بأجمعها صائبة، كما أن بعضها الآخر الذي يمكن أن يكون صائباً في جوهره، ليس هو كذلك بالضرورة في شكله، لأن للتغيرات الاجتماعية متطلباتها التي لابد من الاستجابة لها، في حدود ما لا يتنافى والثوابت، ويصطدم بالخطوط الحمر.
في هذا الجو المتشدد والمتصلِّب نشأ الشيخ الفضلي، حيث الصراع المحموم بين القديم والجديد، فاختار بكل شجاعة أن ينحاز للجديد، بعد أن وجد فيه ضالته المنشودة من الموائمة بين ثوابت الإسلام وأحكامه من جهة، ومتطلبات العصر من جهة ثانية. فترجم ذلك بالانتساب إلى كلية الفقه أولاً، مواصلاً مسيرته الأكاديمية في جامعة بغداد، انتهاءً بجامعة الأزهر بمصر.
وهذه المسيرة كانت مرّة وقاسية على مثل الشيخ الفضلي آنذاك لأن الوضع لم يكن يتقبل ذاك بسلاسة. وما أصعب أن تخالف ما هو سائد، وما أحوجك إلى أن تكون شجاعاً لتقوم به.
الشاهد الثاني: انتماؤه للعمل الإسلامي المنظم
في هذا الجو نفسه استشعر علامتنا الفضلي، وثلةٌ من أهل العلم والغيرة آنذاك، الحاجةَ الماسّةَ إلى تنظيم يقوم على أساس تأمين الحاجة الاجتماعية للتربية الدينية وجني ثمارها، فلم يجد حرجاً في الانتماء، مع ما لفّ ذلك من مخاطر أمنية، حيث المنع الرسمي من قبل الدولة، ومخاطر اجتماعية، حيث الرفض الاجتماعي المطلق في الوسط الحوزوي لدى علماء الدين وطلبة العلم لذلك. ومع هذا وذاك اختار العلامة المكرّم ما وجد أنه صواباً وضرورةً، ولمس الشجاعة في نفسه لاختياره ذاك.
وقد عُرِفت حوزة النجف الأشرف بالصرامة والتقليدية، حرصاً من رموزها وطلابها، على المحافظة على ما يطمئن إلى سلامته وصوابيته لقيام الدليل عليه. الأمر الذي انعكس سلباً على وتيرة التفاعل بين الحوزة العلمية ومستجدات الأحداث. وقد عاصر سماحة علامتنا المكرّم حقبة التمدد الشيوعي والتمرد على التعاليم والمعارف الدينية في العراق إبان حكم عبد الكريم قاسم «1958 - 1963 م». فنشأت فكرة التنظيم الإسلامي، فكان لسماحته شرف الريادة في الانخراط فيه فكان من قياداته ذوي التأثير.
وكان شجاعاً وتقدمياًّ جداًّ في انتسابه وعمله ذاك، بعد أن آمن بصواب الفكرة مع شدة رفضها من قبل قطاعات واسعة في الوسط الحوزوي[8] .
الشاهد الثالث: ممارسة الكتابة والتأليف
لم يكن من المعتاد لدى الأوساط الحوزوية العامة في النجف الأشرف، آنئذٍ، الكتابةُ والتأليفُ في غير العلوم الحوزوية المتعارفة، لذلك فإن من كتب، حينها، وألّف في غير ما تعارف التأليف فيه، عانوا أشد المعاناة، من الاتهام بالفشل الحوزوي، مروراً بأنهم صحفيون، انتهاءً بالتمرد على تقاليد الحوزة. ولهذه التهم وأمثالها قدرة تدميرية هائلة، يستجيب كثير من طلبة العلم لضغطها، تحول بينهم وبين تفجير طاقاتهم الهائلة في التأليف والكتابة.
الشاهد الرابع: احترام حق الغير في الاختيار
قد يحكم الركود الفكري وسطاً من الأوساط العلمية، فما أن يتبنى أحدٌ رأياً «آخر» غير ما هو مألوف، حتى تثار العواصف في وجهه. ولم يكن سماحته ممن يتبنى وجهة النظر هذه، فهو يرى أن من حق صاحب الرأي أن يقول رأيه في حدود الاجتهاد الفكري بعد اكتمال مقدماته وقواعده. وليس لأحد ممارسة الوصاية عليه. وللآخرين الحق أن يُبدوا آراءهم المخالفة، لكن في حدود الاختلاف العلمي دون تجريح شخصي.
وكان يمارس ذلك عملياًّ فبينما نجد بعض أهل العلم يتكتم على «الرأي الآخر»، وقد يضيف إلى ذلك التنكر له ولعلمه، لدواعٍ علمية تارةً، وغير علمية تارةً أخرى. أما الشيخ فلم يكن، فيما عهدته منه، ينطلق من هذا المنطلق، بل كان موضوعياًّ في منتهى الموضوعية، فإذا كان بصدد بحثٍ علميٍّ فإنه يجنبه تماماً من ميوله واختياراته، ليتولى عرض الرأي الآخر بكل ما تتطلبه الموضوعية من الإنصاف. فإذا تطلب المقام المناقشة فإنه يدخل فيها بما ينبغي للعالم أن يراعيه من أصول البحث العلمي.
وسأكتفي بإحالة القارئ الكريم إلى مجموع كتب الشيخ ومحاضراته التي تزخر بالشواهد، على ما قلناه من عرض الرأي والرأي الآخر دون تحيز لطرف دون طرف، ثم الوصول إلى مرحلة الاختيار حسب القواعد العلمية.
وأقتصر على ما نقله لي من أنه لما سافر إلى اليمن أخذ بالبحث عن كتب لعالم يمني، سمع أنه يرى التفرقة بين الفائدة البنكية المعروفة والربا المنصوص على حرمته بين الفقهاء، ليكتب عن رأيه بأدلته التي ساقها صاحب النظرية. وهو شاهد على نبل أخلاقي يفتقده كثيرون بذريعة أن المسألة واضحةٌ ومتفقٌ عليها! مع أن وضوح المسألة والاتفاق عليها، كما لا يخفى، ليسا مسوِّغاً كافياً للتعتيم والتجاهل.
| |
|
|
|
|
|