|
|
عضو فضي
|
|
رقم العضوية : 82198
|
|
الإنتساب : Aug 2015
|
|
المشاركات : 1,849
|
|
بمعدل : 0.48 يوميا
|
|
|
|
|
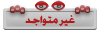

|
المنتدى :
المنتدى الإجتماعي
 التجلي الإلهي... أكبر معجزة مقامة على العقل البشري...
التجلي الإلهي... أكبر معجزة مقامة على العقل البشري...
 بتاريخ : 14-12-2025 الساعة : 08:19 AM
بتاريخ : 14-12-2025 الساعة : 08:19 AM
إنّ التجلّي الإلهي كان ولا يزال من أعظم الآيات المقامة أمام العقل البشري؛ ذلك العقل الذي يتطلّع أبداً إلى جهة العلوّ، ويسعى بفطرته إلى الالتحام بوجودٍ أعلى من ذاته، فيقف عند أبواب الغيب متسائلاً: كيف يظهر المطلق في حدود الممكن؟ وكيف تتنزّل الأنوار الإلهية على صفحات هذا الوجود الكثيف؟
إن التجلّي في اللغة يعني الظهور والانكشاف، فيُقال: تجلّت الشمس في أفق السماء أي ظهرت وأنارت. فكل ظهورٍ بعد خفاء يسمّى تجلّياً. ومن هنا، يكون تجلّي الله لعباده هو ظهور آثاره لهم، وانكشاف صفحاته في الكون والخلق، لا بمعنى رؤيته بالحواس، بل بمعنى أن تنكشف للقلوب آياته، ويتجلّى للعقول نظامه وفعله وقدرته.
وليس للتجلّيات الإلهية عددٌ ولا حدّ، فهي ممتدّة في كل ذرّة من ذرات الكون؛ وفي كل موضعٍ يبلغه العلم، وكل قانونٍ يكتشفه الباحث، هو في الحقيقة بابٌ يُفتح على تجلٍّ جديد، ومعجزة لا تُدرك إلا لمن أبصر ببصيرته قبل بصره.
ولذلك، فإنّ أقصى ما يمكن للعقل البشري أن يقدّمه هو اكتشاف النظام الذي وضعه الله في خلقه؛ فكلّما اتّسعت دائرة الاكتشاف، اتّسعت معها دائرة التجلّي.
إنّ اكتشاف الحقيقة العلمية ليس مجرّد معلومة، بل هو انكشافٌ للوجه الخفيّ من الحكمة، ومعجزةٌ تُقام أولاً على عقل المكتشف نفسه، قبل أن تُقام على عقول الآخرين.
التجلّي في النصوص الدينية
وإذا فتّشنا في النصوص، وجدنا أنّ القرآن والسنّة زاخران بذكر تجلّيات الله لعوالم الملائكة والناس. فمن ذلك ما رواه الصدوق رحمه الله عن الإمام الرضا (عليه السلام) عندما سأله المأمون عن قوله تعالى: ((وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ ))(١)
فقال الإمام (عليه السلام): ((... كانت الملائكة تستدل بأنفسها وبالعرش والماء على الله عز وجل، ثم جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة فيعلموا أنه على كل شيء قدير… وخلق السموات والأرض في ستة أيام… ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شيء وتستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالى ذكره مرة بعد مرة...)) (٢)
إن هذا الخبر العظيم يكشف أن أول تجلٍّ عرفته الملائكة لم يكن عبر السموات ولا الأرض، بل عبر أنفسها، ثم عبر العرش والماء، وهي المظاهر الأولى التي عرّفتها على ربّها. ثم تكاملت معرفتها مع كل حادثة من حوادث الخلق، حتى صارت كلّ مرحلة من مراحل الكون مرآةً جديدة لسطوع القدرة الإلهية.
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ((فتجلّى لخلقه من غير أن يكون يُرى))(٣)
وهذا من أروع التعابير التي تظهر أنّ التجلّي الإلهي لا يقع على العين، بل على الوجدان، وأنّ الله يظهر لعباده دون أن يكون مرئياً بحسّ، بل يُعرف بنورٍ يقذفه في القلب، وبآثارٍ تتجلّى في الخلق، كما ورد عن الإمام علي (عليه السلام)  (بها تجلّى صانعها للعقول))(٤) (بها تجلّى صانعها للعقول))(٤)
أي أنّ الله تجلّى للعقول بآثار قدرته في الأشياء.
الرؤية القلبية: أعمق ميادين التجلّي
ومن لطائف المعارف ما ورد عن أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟
قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة،
قلت: متى؟
قال: حين قال لهم: ألست بربكم قالوا بلى…
ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة، ألست تراه في وقتك هذا؟
إنها ليست رؤية العين، بل رؤية البصيرة؛ تلك التي يصفها الإمام بقوله: ((وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عمّا يصفه المشبّهون والملحدون)) (٥)
وهذه الرؤية هي التجلي الحقيقي، وهو انكشافٌ للحق في القلب. ولذلك، في المناجاة الشعبانية ورد: ((وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة…))
إنه وصفٌ دقيق لرحلة التجلّي، نورٌ يشرق في القلب، فيخرق الحجب، ويصل إلى مقام العظمة القدسية.
أعظم التجليات الإلهية: الأنبياء والأئمة
إذا كان الملائكة قد عرفوا الله بالعرش والماء وخلق السموات، فإنّ أعظم أبواب التجلّي للخلق هم الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فهم الذين تجسّدت فيهم أسماء الله الحسنى، وصاروا: حجّته، براهينه، أدلّاءه عليه، وجهه الذي يؤتى منه، يده المبسوطة بالرحمة على عباده...
فلا يُعرف الله كما ينبغي إلا عبر نورهم، ولا يُهتدي إليه إلا بواسطتهم... محمد وآل محمد (صلوات الله عليهم) هم مرآة التوحيد الأعظم، وهم التجلي الأكبر في هذا العالم.
التجلّي للكفار والمشركين
التجلّي ليس خاصاً بالمؤمنين؛ بل إنّ كل إنسان يتعرّض في حياته للحظات يتجلّى فيها الله لروحه، لكن بدرجةٍ تتناسب مع قابليته. فقد قال تعالى: ((فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ))(٦)
فحين تشتدّ المخاطر، تنكشف النفس على فقْرها، وتتجلّى لها قدرة الله وقهره، فتدعوه مخلصة. إنها لحظة تجلّي الاضطرار؛ حيث يسقط كل ما سوى الله، ولا يبقى في الوجدان إلا حضوره. وبذلك، يكون التجلّي حجّة على كل البشر، فيكون العذر باطلاً يوم القيامة.
تجلّي الله لأنبيائه وأوليائه
أمّا تجلّيه للأنبياء والأولياء فهو مقامٌ آخر، لا يبلغ أحدٌ مداه.
وقد ورد في دعاء السمات: ((وبمجدك الذي تجلّيت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء… ولإبراهيم خليلك… ولإسحاق صفيّك… وليعقوب نبيّك…))
فكلّ نبيّ له نصيب من التجلّي؛ مقامٌ يختصّ به دون غيره، بحسب قابليته الروحية. وأعلى مقامات التجلّي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقد روى الإمام الرضا (عليه السلام) : ((لما أُسري بي إلى السماء… فكشف لي فأراني الله عز وجل من نور عظمته ما أحب))(٧)
وفي رواية أخرى: ((إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب)) (٨)
وهي رؤية قلبية، لا تدخل في حدود الحسّ ولا الإدراك المادي.
وهكذا، يتّضح أنّ التجلّي الإلهي ليس مفهوماً غيبياً مجرّداً، ولا هو حادثةً تقع في زمنٍ دون آخر، بل هو النبض الخفيّ الذي يسري في كل ذرة من ذرات هذا الكون، ويجعل من الوجود كتاباً مفتوحاً على صفحات القدرة والرحمة والحكمة. لقد كان التجلّي، منذ فجر الخليقة، هو الجسر الذي عبرت منه الملائكة إلى معرفة ربّها، وهو السراج الذي تهتدي به قلوب الأنبياء عليهم السلام ، وهو النور الذي يتساقط على بصائر المؤمنين كلّما صدقوا في طلب الحقّ.
وإذا كان الوحي والأنبياء هم أعظم التجليات التي تشهد للحقّ في ميدان الهداية، فإنّ العلم الحديث، على نحوٍ آخر، قد صار باباً من أبواب التجلّي الكوني؛ إذ انكشفت للعقول قوانين دقيقة، ونُظُم ثابتة، وارتباطات محكمة بين أجزاء الوجود، تكاد تنطق بأن وراء هذا العالم حكمةً قاصدة، و غايةً مرسومة، و عقلاً مدبّراً.
ومن هنا، لم يكن غريباً أن يقف المختصّون في ميادين الفيزياء والبيولوجيا والكونيات أمام هذا الانسجام المذهل، وهذه الدقة الفائقة، وقفة المتأمّل المبهوت. بل إنّ كثيراً منهم، حين لامست أنظارهم التجليات العميقة في بنية الكون، توصّلوا – من حيث يشعرون أو لا يشعرون – إلى ما يُعرف اليوم بـ نظرية التصميم الذكي، وهي ليست سوى قراءة عقلية لآيات التجلّي الموزّعة في أرجاء السماوات والأرض.
لقد أدرك هؤلاء العلماء أنّ هذا الكون ليس وليد صدفةٍ عمياء، ولا نتاج فوضى بلا معنى، بل هو بناء قائم على معادلات دقيقة، وثوابت محسوبة بميزانٍ لا يختلّ، حتى قال بعضهم: إنّ تغيّر أحد هذه الثوابت بمقدار جزء من مليار من وحدة قياسه كافٍ لدمار الكون أو استحالة الحياة فيه.
وهذا نفس ما عناه القرآن منذ قرون: ((ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت))
إنّ العقل البشري – مهما بلغ – يقف حائراً أمام هذه الهندسة الكونية العظيمة. وكلّما تقدّم العلم، ازداد العقل دهشةً، وازدادت التجليات وضوحاً. فالتصميم الذكي ليس إلا اعترافاً علمياً بأنّ وراء هذا الوجود مهندساً أعظم، نظّم عناصره وأقامه على قواعد محكمة، وفتح للإنسان أبواب التأمّل فيه.
وبذلك، يتحد العلم مع الدين، وينسجم العقل مع القلب، ليقولا بصوتٍ واحد:
إنّ هذا الكون كتابٌ من كتب الله، تتجلّى صفحاته بالعظمة والحكمة، ومن تأمّله حقّ التأمّل عرف أنّ كل شيء فيه ينادي:
إنّ وراء الوجود وجهاً يتجلّى، ونوراً يهدي، وحكمةً لا يبلغها الوصف، وما الإنسان إلا مسافرٌ في طريق التجلّي، يسعى أن يكون قلبه مرآة يليق بأن ينعكس عليها نور الله.
والحمد لله رب العالمين
المصادر:
(١)- سورة هود الاية ٧
(٢)- الشيخ الصدوق- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج١- ص ١٣٤
(٣)- ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ١٩٠٥
(٤)- نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج ٢ - ص ١٢١
(٥)- التوحيد - الشيخ الصدوق - ص ١١٧
(٦)- سورة العنكبوت الاية ٦٥
(٧)- -الشيخ الصدوق- التوحيد- ج١- ص ١٠٨
(٨)- الشيخ الكليني- الكافي - ج ١ - ص
العتبة الحسينية المقدسة
| |
|
|
|
|
|