|
|
شيعي حسيني
|
|
رقم العضوية : 13143
|
|
الإنتساب : Nov 2007
|
|
المشاركات : 7,797
|
|
بمعدل : 1.17 يوميا
|
|
|
|
|
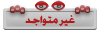

|
كاتب الموضوع :
أرجوان
المنتدى :
المنتدى الفقهي
 بتاريخ : 05-06-2008 الساعة : 01:24 AM
بتاريخ : 05-06-2008 الساعة : 01:24 AM
وعلى هذا الاساس
يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين إزدهار علم الاصول في نطاق التفكير الفقهي السني وإزدهاره في نطاق تكفيرنا الفقهي الامامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الاصول ترعرع وإزدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وإزدهاره في نطاقنا الفقهي الامامي، وذلك لان المذهب السني كان يزعم إنتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله فحين إجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد إبتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الامامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي لان الامام إمتداد لوجود النبي فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الاماية في الاستنباط أقل بكير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للاحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الاصول ولهذا نجد أن الامامية بمجر ان انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بإنتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الاصولية وإقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الاصولي لم توجدل لدى فقهاء أصحال الائمة بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهما السلام على المستورى المناسب لتلك المرحلة، ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجهها عدد من الرواه إلى الامام الصادق وغيره من الائمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الاسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الاصولي عندهم. ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الائمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الاصولية كهشام بن الحكم من أصحاب الامام الصادق الذي روي أنه ألف رسالة في الالفاظ.
جواز عملية الاستنباط ما دام علم الاصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة فيجب أن نعرف قبل كل شئ موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لاحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة ؟ والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لاننا حين نتسأل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا ؟ يجي الجواب على البداهة بالايجاب، لان عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا إستدلاليا، ومن البديهي أن الانسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا إستدلاليا. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش، فقد إستخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط. وطرح السؤال هكذا هل يجوز الاجتهاد في الشريعة ؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها - أدت
إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الاصول كله لانه إنما يراد لاجل الاجتهاد، فإذا الغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الاصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي، وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو " بذل الوسع للقيام بعمل ما " وقد إستعملت هذه الكلمة - لاول مرة - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها وهي القاعدة القائلة: " إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص ". والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجع في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل
البيت (ع) والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملة هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الائمة إلى القرن السابع فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصارد الحكم، وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الائمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتبا أسماه " الاستفادة في الطعون على الاوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس ". وصنف هلال بن إبراهيم بن ابي الفتح المدني كتابا في الموضوع بإسم كتاب " الرد على من رد آثار الرسول وإعتمد على نتائج العقول "، وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي ابن اسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول: " أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك بإستنباطه وإستدلاله معنى أفعال الخضر حتى إشتبه عليه وجه الامر به، فإذات لم يجز لانبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الامم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك... فإذا لم يصلح موسى للاختيار - مع فضله ومحله - فكيف تصلح الامة لاختيار الامام، وكيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعية وإستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ". وفي أواخر القرن الرابع يجى الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم
على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر ويكتب كتابا في ذلك بإسم " النقض على ابن الجنيد في أجتهاد الرأي ". ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول: " إن الاجتهاد باطل، وإن الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد ". وكتب في كتابه الفقهي " الانتصار " معرضا بابن الجنيد - قائلا: " إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر " وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: " إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به ". وإستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا: " إما القياس والاجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة إستعمالها ". وفي أواخر القرن السادس يستعرض إبن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لاحدى البينتين على الاخرى ثم يعقب ذلك قائلا: " ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا ". وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الاساس إكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الامامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والايمان ببطلانه.
| |
|
|
|
|
|